نبذة موجزة
في مدينة ساحلية تُدعى الميناء الزمردي، يلتقي شاب بشري اسمه سليم بفتاة قادمة من عالم آخر تُدعى ليارا، تتحطّم مركبتها على الأرض وتُحتجز قسرًا بين حدود الفيزياء الأرضية وتعقيدات نفوذ منظمة سرّية تُسمّى “مجلس الظلال”. ليارا “حارسة عبور” من حضارة سماوية، تحمل شيفرة أنشودة قديمة قادرة على فتح بوابة الأثير، لكنها فقدت مصدر طاقتها النادر، وأصبح الرجوع إلى موطنها مستحيلًا. يعمل مجلس الظلال على مطاردتها للاستيلاء على ما تملكه وتوظيفه للهيمنة الكونية، ويقف سليم—ذلك الشاب الذي يحمل قلبًا شجاعًا وإحساسًا عميقًا بالمسؤولية—ليحميها مهما كلّف الأمر. بين مطاردات عبر الأزقة، وملاذات في الجبال، وأحجار طاقة وأنغام سماوية، يبذل سليم كل ما لديه، ويستعد للتضحية بحياته كي تعود ليارا إلى ديارها. القصة تتبع انكساراتهما وانتصاراتهما، وتكشف عن معنى أن يواجه الإنسان الشرّ لئلّا يتحوّل الكون إلى ظلال. إنها حكاية حب وتضحية وانتماء، حيث يصبح الأثر أخلد من الذكرى، والترنيمة طريقًا إلى الوطن.
الشخصيات
- سليم: شاب في أواخر العشرينات، حادّ الذكاء رغم تواضع حياته، يعمل تقنيًا بحريًا في الميناء ويهوى قراءة الخرائط القديمة ومجلّات الفلك. قلبه كبير، وضميره حيّ، وسرعان ما يتحوّل من مراقب إلى فاعل حين يقترب الخطر.
- ليارا: فتاة من عالم يُعرف بمدارات الأوريون، حارسة عبور تحمل شفرة أنشودة قديمة تُسمّى “ترنيمة الفتح”، قادمة في بعثة استكشافية، تتحطّم مركبتها وتفقد خيوط العودة. قويّة حين يلزم، رقيقة في جوهرها، تخشى أن تصير عبئًا على من يساعدها.
- ميرا: صديقة سليم منذ الطفولة، مبرمِجة ومُحلّلة بيانات، بارعة في الاختراق وتجاوز أنظمة المراقبة، لسانها حادّ وضميرها نقيّ، تنضم لدعم سليم و”ضيفته السماوية”.
- الشيخ نحير: حارس جبل السديم، حكيم عجوز يقيم قرب محراب قديم يحوي حجرًا نادرًا يسمّى “قلب السديم”، يعرف أسرار الأنغام والأحجار وينطق الحق بصدقٍ وصرامة.
- أركان: قائد عمليات “مجلس الظلال”، عقل بارد ويد قاسية، يؤمن بأن السيطرة شرطٌ للنجاة، لا يرى في الكائنات الأخرى إلا أدوات.
- يوسف: بحّار مسنّ أعتقته التجارب، يملك مستودعًا عند الرصيف القديم، يُخفي ماضيًا معقّدًا ويفهم سليم بفطنة، يقدّم العون حين تضيق الخيارات.
الفصل الأول: سقوط الضوء على الميناء الزمردي
الميناء الزمردي جهة من الأرض لا تُسجّل في خرائط السائحين، لكنها تعيش في وجدان أناسها كأغنية مالحة؛ يُمسدها النسيم، وتزخرفها قوارب الصيادين المتهالكة، وتُحرسها منارات بعيدة تلوح لليل كأهدابٍ مُضيئة. هناك، عاش سليم، يداً على خشب السفن، وعيناً على السماء، يُصلح المضخّات ويقرأ في أثناء الانتظار مجلّات الفلك وخرائط قديمة، يبحث في النجوم عن شيء لا يسميه، لكنه يحسّه.
في تلك الليلة، لما اختنق البحر بغيومٍ كالحديد وتكسّر المطر فوق المراسي، رأى سليم ما لم ير من قبل: شقًّا من الضوء الأزرق يصطكّ في السماء كأن أحدهم مزّق قماشة الليل بظفرٍ كوني. ضوءٌ لم يكن برقًا؛ كان انفتاحًا، لمعةً في نسيج ما وراء الرؤية. ثم دوّى صوتٌ عميق، كقلب جبلٍ تهشّم.
تحرّك سليم بلا تردّد—من يعرف البحر يعرف أنه حين ينادي لا ينتظر. عبر الأزقة، تخطّى الحاجز الحديدي عند الرصيف التاسع، وهبط إلى الشاطئ الحجري خلف المخازن المهجورة. هناك وجد أثر الاصطدام: حفرة شبه دائرية، ورائحة معدنية غريبة كأن الحديد نفسه احترق. وسط الحطام، جسمٌ فضّي مُحدّب، لا يشبه أيّ شيء عرفه، كأنّه ثمرة من نجمةٍ قطفتها يدٌ خفية وألقتها على الرمل.
لم يكن في ذلك المكان رجال أمنٍ بعد، وكأن السماء منحته الدقائق التي تفرّق بين الشاهد والناقل. اقترب، قلبه يُحدّثه: ما يسقط من السماء ليس دائمًا شرًّا؛ أحيانًا يسقط قدرك. وعندما حلّ قرب الجسم، رأى فتاة ملقاة على الرمل، مُلتفّة بزيّ فضّي يلمع تحت المطر، شعرها كخيوط ليلٍ مزدهرة بضوءٍ داخلي، ووجهها رائق كقصيدة لم تُكتب بعد. اقترب، وضع كفّه قرب فمها—أنفاس. ضعيفة، لكن تُقاوم.
همس إلى نفسه: “لن أدعكِ تموتين هنا”. وفي تلك اللحظة، لم يكن أمامه سوى يوسف، صاحب المستودع في الرصيف القديم. حملها بحذر، كأنّه يحمل سرًّا تواطأت عليه الكواكب، وسار بها في الظلّ نحو مخزن يوسف، ذاك الذي يعجّ بقطع السفن، صفائح زيت، ورفوفٍ تعبت من حمل القصص.
يوسف لم يطرح أسئلة كثيرة، عينا الرجل القديم تُدرك أن بعض الحكايات تنضج إذا سُقيت بالصمت. فتح بابًا داخليًا لمخزنٍ صغير، فرش بطانيات، وقال: “احمها من الريح… وسأحرس الباب.” سليم، وهو يلفّ جسد الفتاة ببطانية جافّة، شعر بنبضه يُقارب نبضها، كأن القلبين—رغم اختلاف سمائهما—يبحثان عن إيقاعٍ واحد.
أفاقت الفتاة قبيل الفجر، نظرت إليه بعينين ليستا بلون واحد؛ فيهما ظلال بنفسجية تتبدّل، ليست كعيون البشر لكنها ليست غريبة عن القلب. حاولت الكلام، فخرج صوتها كهمسٍ من ذبذباتٍ لا يعرف الأذن العربية اتّساعها. ابتسم سليم بخفةٍ لا تخون جدّيته وقال: “أنتِ بأمان.” ردّت بشيء يشبه “أمان” لكنها نطقتها بنبرة تُغني ولا تقول. كان في حضورها جمال غير مفترَس، قوّة رقيقة تشبه الماء حين يعبر ضيقًا فلا ينكسر.
حين طالعهم الصباح، دخل يوسف بطبق شايٍ ثقيلٍ كأنما جاء من مواقد سلالات، وقال: “ما اسمها؟” أجاب سليم: “لا أدري… ولكن في عينيها ليلٌ جميل.” ضحك يوسف بتلك الضحكة التي تنقذك من ثقل اللحظة وقال: “احذر يا ولدي… الليل الجميل عادةً يجرّ المغامرات.”
في الأيام التالية، ظلّ سليم يقرأ في ملامح الفتاة اللغة التي لا تُقال. سمّاها “ليارا”—اسمٌ خرج من بين أوراق خرائطه القديمة، اسمُ نجمةٍ في أساطير بلدةٍ بعيدة. ولاحظ أن جسدها يبعث ضوءًا واهنًا يسكن حين ترتاح، ويشتعل حين تنزعج. كانت تُشير إلى السماء إذ يجنّ الليل، وترسم بأصابعها خطوطًا لا تراها عينه لكن تراها روحه، وكأنها تُمسك بخرائط لا نملك جبّتها.
بعنايةٍ وبِحيلةٍ وتعاطف، علّمها كلماتٍ عربية بسيطة، وأخذ منها مقاطع صوتية تُشير إلى ما تريد قوله. شيئًا فشيئًا، وُلدت جملة: “أنا… ليارا.” ثم جملة أطول: “المركبة… تحطّمت. الطاقة… ضاعت. لا عودة.” حين قالت “لا عودة”، كان في صوتها ما يكفي ليجعل حجارة الرصيف ترثي. حدّق سليم بملامحها، وشعر أن “لا عودة” ليست تقريرًا؛ هي نداء.
الفصل الثاني: مجلس الظلال وأنشودة الفتح
تعلّم سليم من ليارا، بنبرةٍ غير مكتملة ولكنها صادقة، أنها “حارسة عبور”—مهمتها رعاية مفاتيح بوابات الأثير التي تصل بين العوالم البعيدة، وأن مركبتها كانت في بعثةٍ إلى مدارٍ يسمّى “حافة الأوريون” لجلب قياسٍ من طاقة نادرة تُدعى “شعاع الكوارتس السماوي”. اضطربت البعثة، ففُتح شقّ غير مستقرّ في المِظَلّة الكونية، فانزلقت المركبة عبر انحناءٍ خاطئ، وسقطت على الأرض. ما عاد ممكنًا أن تعود؛ لأن “ترنيمة الفتح”—الأنشودة التي تُغنيها بوابة الأثير لتستجيب—فقدت قلبها النابض: حجرًا يسمّى “قلب السديم”.
حين كانت تشير إلى صدرها وتقول “قلب السديم”، كان الضوء البنفسجي يرقص تحت بشرتها كوميض حنين. قالت: “قلب السديم… هنا—لا. سُرق؟ ضاع؟ لا أعرف.” وكان في هذا “لا أعرف” كسرٌ صغير يشفّ عن خوفٍ كبير: أن يكون “مجلس الظلال” قد سبقها.
سمع سليم—من خلال ميرا التي تتعامل مع شبكاتٍ أعمق من سطح الإنترنت—عن حركةٍ غير مألوفة قرب الميناء. مركبات سوداء، رجال بملابس تكتيكية، طائرات مسيّرة بصمتٍ سجاديّ. قالت ميرا: “يا سليم، هناك خيوطٌ لجهةٍ استخباراتية خاصة تُدعى ‘مجلس الظلال’، يلتقطون إشارات غريبة من البحر… ويتحرّون عن حادثٍ سمويّ.” عَقّب يوسف، الذي لا يثق في أي شيء لا يفوح منه زيتٌ بحري: “مجلس الظلال؟ سمعنا الفزّاعة هذه من قبل… ناسٌ يعملون في الظلّ، ولا يتركون وراءهم إلا رجالًا بلا أسماء.”
لم يمضِ طويلًا حتى اصطكت الخطوات قرب المستودع. كاميرات ميرا المُخبّأة في منافذ التهوية التقطت وجوهًا جزئية—أركان، قائد عمليات المجلس. عينان زجاجيتان، لا يَرِقّان لشيء. جاءوا بدعوى تفتيش روتيني، لكن أصابعهم تُمسك بالهواء كأنها تُمسك بذنبٍ ما. اختبأ سليم وليارا في غرفةٍ خلفية، بينما وقف يوسف يصدّ الباب بابتسامة رجلٍ لم يعد يخاف أن يخسر لأن ما يجب أن يخسره قد خسره بالفعل. ألقى أركان نظرةً على الرفوف، على الأدوات، ثم قال ببرود: “أتعامل مع حادث سقوطٍ قرب الرصيف التاسع. نحتاج تعاونك.” ردّ يوسف: “الدنيا تسقط علينا كل يوم يا سيدي… وأحيانًا يسقط الحقّ كذلك. مستودي نظيف.” ومضى اللقاء كأنه لم يحدث، لكن سليم فهم الرسالة: المطارِدون على الطريق.
في مساءٍ تُكثر فيه القطط من التحديق في الفراغ، قال سليم لميرا: “نحتاج أن نُخرجها من الميناء… نحو الجبل.” كان قد سمع—من خرائطٍ أكثر قِدَمًا من البلاد نفسها—عن جبلٍ يسمّى “السديم”، حيث يقع محراب قديم يُقال إن فيه حجرًا من النجوم: “قلب السديم.” ارتسمت على وجه ميرا ابتسامةٌ تُشبه فكرةً ناجحة: “هناك ممرّاتٌ جانبية، شبكاتٌ قديمة للصرف، ونقاط عمياء في شبكة المجلس. أستطيع أن أفتح لك نافذة عبور قصيرة.” قال يوسف، وهو يُعِدّ سيارةً قديمة بخزّانٍ ممتلئ: “الطريق طويل. لكننا لا نترك البحر يغرق من غير قارب.”
انطلق الثلاثة—سليم، ليارا، والميرا التي تُمسك بالخيوط التقنية من بعيد—في رحلةٍ غير متوازنةٍ بين الأرض والسماء. في الطريق، صار الليل شريكًا في الهروب: يفتح لهم الأبواب حين يضيق النهار. ليارا، حين يشتدّ الخوف، تُغمض عينيها وتُهمهم بأنشودة قصيرة، لا تُشفّرها الكلمات لكنها تُفكّك الرعب. كان سليم يسمّيها “ترنيمة الطمأنينة”.
عند حواف المدينة، ارتفع صليل معدني—طائرات مسيّرة تُضيء كعيون الذئاب. صرخ سليم: “أرضحوا!” انزلقت السيارة في منعطفٍ ضيقٍ نحو ساحة سكنية مهجورة، وفي اللحظة التي التقت فيها أجنحة الطائرات بمقدمة السيارة، خرجت من هاتف سليم نغمة ميرا: “اختراقٌ للحزمة. ثلاث ثوانٍ.” في تلك الثلاث ثوانٍ، انطفأت العيون، وكأن أحدًا أطفأ الليل نفسه. أعادوا تشغيل المحركات وانطلقوا. قال سليم بابتسامةٍ مُرهقة: “لو أن ميرا كانت نجمة… لكانت نجمةً ذات أصابع.”
الفصل الثالث: جبل السديم وحارس الأنغام
جبل السديم ليس عظمًا في سلسلة جبالٍ مألوفة؛ هو كتلة من زمنٍ مُحدّبٍ على نفسها، يتنزّه حولها الضباب كطائرٍ ينسى أن له بيتًا. عند سفحه، تختبئ حكاياتٌ لا تُريد أن تُروى إلا لمن يفهم أن سرّها ليس في الكلمات. الصعود إليه يقتضي أن تقول للريح “اسمحِي”، وأن تقول لصبرك “أطالُك”.
عند صخرةٍ تُشبه منبرًا قديمًا، وجدوا بابًا محفورًا بنقوش لا يُخطئها القلب: خطوطٌ تُذكر بالمدارات، بالأنغام، بالأحجار التي لم تلدها الأرض. طرق سليم بخفةٍ، وكان ظنّه أنه سيطرق مرّةً أخرى، لكن الباب انشقّ كأنّه كان يستمع منذ قرونٍ لخطوة هذا الشاب تحديدًا. خرج رجلٌ بعمرٍ يكاد يساوي عمر الجبل، لحيته كثلجٍ مرّ عليه شتاءٌ كثير، وعيناه كسراجين في خيمةٍ بعيدة.
قال الشيخ: “وأنتم؟” أجاب سليم: “نطلب حجرًا ليس من الأرض.” نظر الشيخ إلى ليارا، وتغيّر الهواء. قال: “يا بنت المدارات… لقد تأخّرْتِ. لكن الذي تأخّر لا يعني أنه لن يصل.” دخلوا المحراب، سقفه خريطة نجومٍ محفورة، وسطه منصة عليها بلورةٌ خضراء يشوبها بنفسجيٌ خافت—قلب السديم. سأل سليم: “وهل هذا الحجر يُعيد لها الدرب؟” أجاب الشيخ نحير: “الحجر يُضيء، والأنشودة تفتح، والقلوب تُوقّع. لكن لكل فتحٍ ثمن.”
انحنى الشيخ على البلورة، قال بنبرة من يعرف جرحَ الكواكب: “قلب السديم لا يُستثار إلا إذا اتّحد نَغمُ الحارسة بنبضٍ بشريّ. البوابة تكره الوحدة؛ لذلك لا تفتح إلا حين تتأكد أن عبورها لن يكون قرار عقلٍ وحده، بل عهد قلبين. من يوقّع العهد، يكون هو ‘المرساة’: يدفع الطاقَة اللازمة، وقد يكون ثمن ذلك حياته أو ذاكرته أو كِلاهما، حسب ما تقتضيه الأنشودة وتطلبه البوّابة.” سكت، ثم قال لسليم مباشرةً: “المرساة غالبًا تكون بشرية… لأن البشر، أكثر من غيرهم، يُتقنون معنى التضحية.”
تجمّدت الكلمات في حلق سليم، لكنها لم تمت. نظر إلى ليارا، رأى في عينيها الارتباك والخوف والغضب من القدر الذي يطلب ثمنًا قاسيًا. قال سليم بلغةٍ هادئة لا تُخيف وإن قالت الحقيقة: “لو طلبت البوابة حياتي… سأعطيها.” صاحت ليارا، كأن الصوت أخيرًا انكسر واختارت الأرض أن تسمعه: “لا! لا تُقسِم هنا. أنت لست ثمني.” أجابها الشيخ وهو يضع كفًّا على قلب السديم: “العهد ليس ثمنًا لأحد. هو جسرٌ يُبنى من حبّ… وكل جسرٍ يحتاج حجرًا يُلقى ليتمّ البناء.”
قبل أن يكتمل الحديث، اهتزّ المحراب اهتزازًا لا يأتي من داخل الجبل، بل من خارجه—انفجاراتٌ صغيرة، طنين أجهزة، وهمسُ رجال يلبسون الليل كدرعٍ حديث. قالت ميرا—بصوتٍ من الهاتف—“وجدونا.” تنفّس سليم كمن رأى البحر يُقرّب عليه موجه الأكبر. قال الشيخ: “لن يدخلوا المحراب بسهولة. لكنكم تحتاجون التفعيل الآن، قبل أن يُفسدوا الإيقاع.” وقف سليم أمام البلورة، أخذ نفسًا كمن يوقّع عقد عمره، ثم نظر إلى ليارا وقال: “إذا فتحت البوابة… عودي. لا تُعاركي على الذكرى؛ الذكرى إذا استُطعمت بالدم لا تعود ذكرى، تعود جرحًا. عودي، واتركي لنا هذا الأثر… الأثر يكفينا.”
الفصل الرابع: معركة الأنغام والظلال
دخل رجال مجلس الظلال الكهوف المتفرّعة، يتقدّمهم أركان. كان يظنّ أنه يطارد تقنية، ولم يفهم أنه يطارد عهدًا. أطلقوا طائراتٍ صغيرة ترسم خرائط حرارية، وحاولوا التشويش على إشارات ميرا من بعيد. الجبل، رغم شدّة قراره، تذمّر من ضجيجهم: الصخور ارتجّت، والنقوش أضاءت لدقائق ثم خمدت كأنها تُحاول أن تُذكّر البشر بأنهم هنا ضيوف، لا أصحاب.
وقف الشيخ نحير عند مدخل المحراب، رفع عصاه، وأطلق من البلورة هامشًا من الضوء الأخضر الذي صنع قصيدةً تحوّلت فجأةً إلى حاجز. قال سليم لميرا: “الوقت!” ردّت ميرا: “ثلاث دقائق… أعدّ لك إيقاعًا موجّهًا.” وضعت ليارا كفّها على البلورة، وأغمضت عينيها. خرج من حنجرتها صوتٌ ليس صوتًا، بل شلالُ أنغامٍ تُشبه ترتيبًا لأكوانٍ صغرى. قلب السديم استجاب. الضوء البنفسجي عاد قويًا، والأخضر انشطر عنه نغمٌ ثالث، كأن الحجر صار آلةً مِزماريةً من نور.
ثم فعل سليم ما لا يفعله إلا من فهم تمامًا معنى العهد—وضع كفّه الأخرى على البلورة، وقلبه مُستعدٌ ليكون المرساة. حرارةٌ اجتاحت جسده، ليست حرارة نارٍ من خشب، بل حرارة توازنٍ يُعاد ترتيبُ اتحادٍ بشريّ مع أنغامٍ ليس لها مرجع. رأى سليم، وهو مُغمض، أشياء لا تُرى بالعين: قوارب طفولته، وجه أمّه وهي تمسح العرق من جبينه، أحلامه التي لم يقطع نصفَها بعد؛ ثم رأى ليارا—وجهها حين تسمّي الخوف وترعاه، إنشادها حين يصبح الصمت مرعبًا، ضحكتها النادرة التي تسقط كحبةِ نيزكٍ صغيرة فتُصوّت دون أن تجرح.
في اللحظة نفسها، اخترق أركان الحاجز الجزئي بقنبلة نبضيّة معدّلة. انفجر الضوء الأخضر عند المدخل، وتفتّت إلى خطوطٍ مُهتزة. أمسك سليم بيد ليارا بقوةٍ أليفةٍ كأنها تُمسك به منذ زمن، قال: “لا تنفلت الأنشودة.” ردّت: “أبقِ قلبَك.” دخل رجال المجلس، أطلقوا أطواقًا صاعقةً على الشيخ، سقط لكنه لم يمت—عصاه ظلّت تُصدر طنينًا يقاوم، كقنديلٍ يرفض أن يُطفأ حتى لو غرق البحر بأكمله.
اقترب أركان بالسلاح الموجّه نحو ليارا، نظر إلى البلورة وقال: “هذا ما نحتاج. السيف الذي يشقّ السماء.” رفع سلاحه، لكن سليم انقضّ عليه كمن رأى أخيرًا الشكل الحقيقي لعدوّه: ليست البنادق ولا الرجال؛ إنه فكرٌ يختزل الكون في أدوات. اصطدم سليم بكتف أركان، انحرف السلاح، خرج منه نبضٌ أصاب سليم في صدره، ألمٌ حادّ كأن شيئًا اقتطع وترك مكانه فراغًا باردًا.
كدت الأنشودة أن تتعثر، لكن ليارا رفعت الصوت—والصوت حين يُرفَع ليس دائمًا قسوة؛ أحيانًا يكون شجاعة. البوابة، هناك أعلى المحراب، فتحت عينًا من نورٍ أبيض—شقّ في سقف الكهف، يُشبه بداية قصيدة جديدة. قال الشيخ، وهو ينهض بعزمٍ كمن يوقّع اسمه الأخير: “الآن!
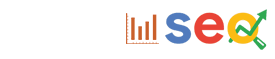
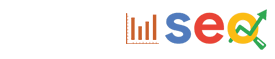







0 تعليقات